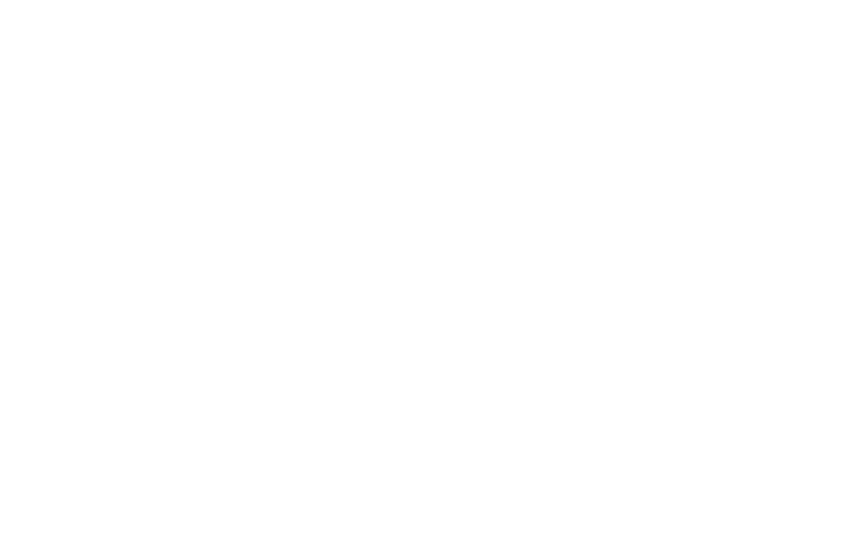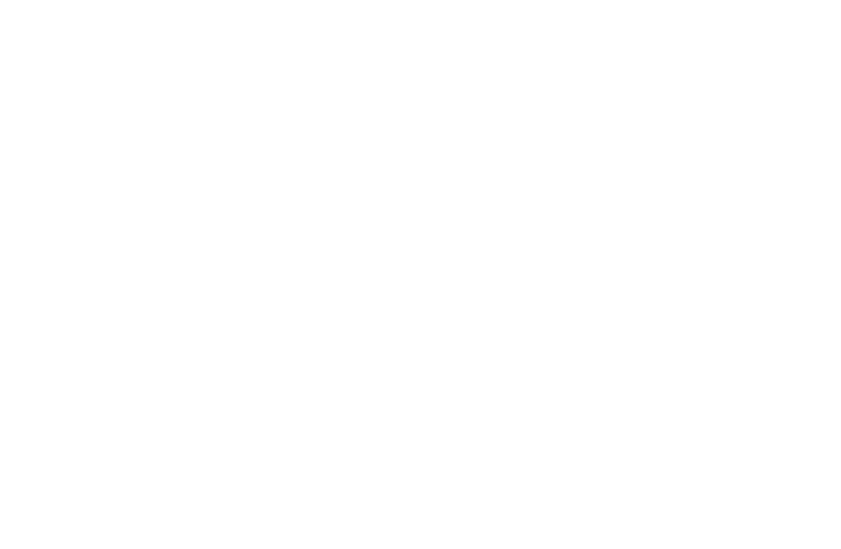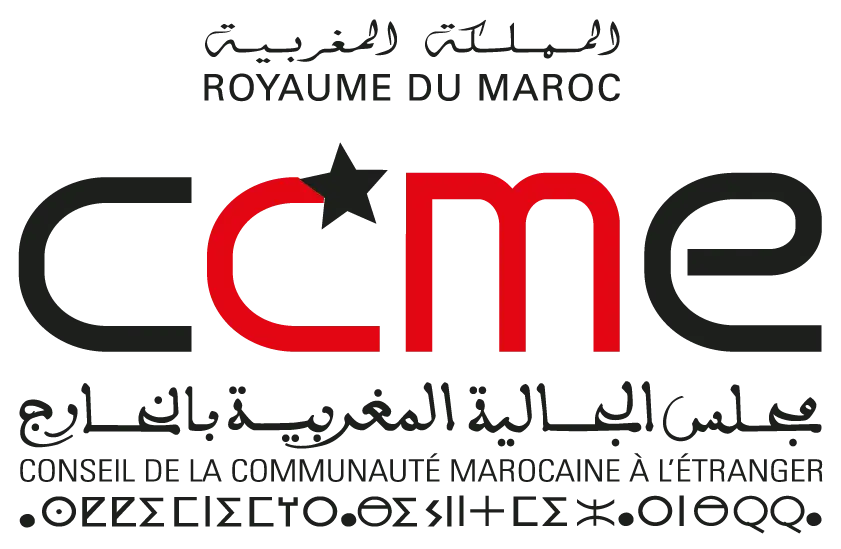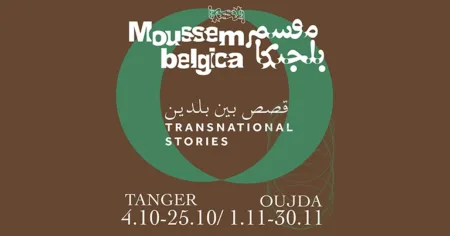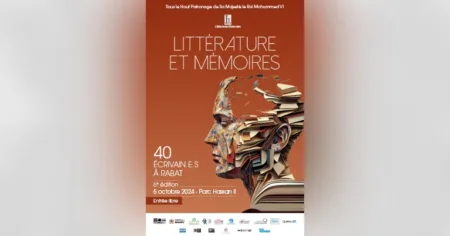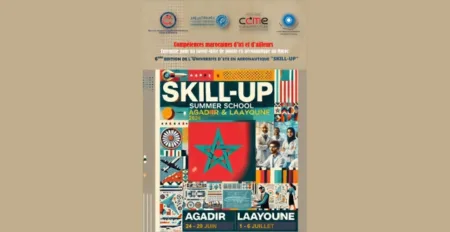احتضن رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج بالمعرض الدولي للنشر والكتاب اليوم الخميس 20 فبراير 2014 في فقرة “فضاء النقاش” لقاء ثقافيا بعنوان: “التحركات البشرية، الهجرة والتبادل بالبلاد المغاربية”، بمشاركة كل من الباحث ميمون أزيزا أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس ومتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية في الفترة المعاصرة، والباحث محمد أمطاط الحاصل على الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ويشتغل أستاذا مساعدا للتعليم العالي بالمركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم بالرباط، وحمدي يمن الباحث في مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة بتونس، ونبية حدوش وهي أستاذة جامعية خبيرة في مجال التنمية، وأستاذة باحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وبكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
تطرق محمد أمطاط في مداخلته إلى الحديث عن الجزائريين في المغرب ما بين 1830 و 1962، ورصد مجموعة من الهجرات، منها الهجرة الكبرى أيام الاستعمار الفرنسي، حيث تشكل هذه المرحلة مرحلة حاسمة في المسار التاريخي المغاربي، وذلك بدخول فرنسا للجزائر وجعلها مستعمرة فرنسية.
وأشار أمطاط إلى أن مجموعة من الجزائريين من علماء وفقهاء وسياسيين أعلنوا في تلك الفترة رفضهم العيش في دولة يحكمها النصارى، وكانت بمثابة هجرة إلى بلد مسلم، وصدرت مجموعة من الفتاوى تقول أنه إذا استطاع المسلم أن يهاجر حتى لا يبقى تحت سلطة كافرة فعليه الهجرة، وكانت مدن فاس خاصة، وتطوان ووجدة من أهم المدن التي توجه إليها الجزائريون في تلك الفترة.
وأوضح الباحث المغربي أن السلطان عبد الرحمن بن هشام ملك المغرب آنذاك قدم للمهاجرين الجزئريين مختلف أشكال الدعم (توظيف الفقهاء في جامعة القرويين، والعسكريون أدمجوا في الجيش…)، كما قبل السلطان طلب المهاجرين الجزائريين تشكيل نقابة للمهاجرين التلمسانيين.
وأشار أمطاط إلى أنه في الفترة ما بين 1912 و 1956 كان المغرب والجزائر معا تحت الاحتلال؛ فدفعت فرنسا مآت الجزائريين الذين يتقنون الفرنسية من أجل الوساطة بالمغرب خاصة في فترة العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي.
من جهة أخرى بين الباحث أنه مع نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات حدث نوع من التحول في نظرة المغاربة لهؤلاء الجزائريين
المهاجرين خاصة مع تدني الجانب الاقتصادي في المغرب فانكسرت جسور الإخاء.
ومع استقلال المغرب، أكد أمطاط أن كل الوثائق تشير إلى أنه ما بين 1956 و 1962 كان الدعم المغربي كبيرا للجزائريين خاصة جماعة وجدة؛ سياسيا وماليا وعسكريا… كما ذكر الاتفاقية التي وقعها الراحل الحسن الثاني مع فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية سنة 1960 حول مسألة الحدود بين المغرب والجزائر، وأشار إلى أن هؤلاء الذين دعمهم المغرب وقاموا بانقلاب في الجزائر قالوا لسنا ملزمين بما قامت به الحكومة الجزائرية المؤقتة من توقيع لاتفاقية الحدود مع المغرب.
وختم محمد أمطاط مداخلته بقوله إنه منذ تلك الفترة والجزائر في نزاع مع المغرب رغم كل ما قدمه لها المغرب من دعم في أوقات الشدة على كافة المستويات.
أما مداخلة الباحث ميمون أزيزا فتطرقت إلى الهجرة المغربية إلى الجزائر، والتي انتعشت لعدة أسباب منها أن الجزائر كانت مستعمرة متقدمة اقتصاديا، وأنه بعد مرور عشر سنوات على استعمار الجزائر تطورت البنيات المختلفة التي أنشأتها السلطات الفرنسية، مما أغرى المغاربة للهجرة الموسمية إلى الجزائر.
وأضاف أزيزا أنه مع بداية القرن العشرين ازدادت الهجرة المغربية إلى الجزائر بسبب عامل الجفاف، وكذا وجود فرص الشغل وأجور مرتفعة خاصة في وهران، وكانت وسائل المواصلات التي تربط المغاربة بالجزائر قد اعتمدت بشكل رئيس على ميناء مليلية، كما كان هناك من يهاجر عبر اجتيازه لنهر ملوية الذي كان يشكل خطرا خاصة في فصل الشتاء.
وختم ميمون أزيزا مداخلته بالإشارة إلى أن الهجرة المغربية إلى الجزائر قد أفادت بشكل خاص أهل الريف ليصبحوا فيما بعد مهاجرين نحو أوروبا، وذلك بفعل ما راكموه من إمكانات مادية سمحت لهم بالتوجه نحو الضفة الأخرى.
من جهة أخرى، تطرقت مداخلة الباحثة نبية حدوش إلى موضوع التحركات البشرية والهجرة والتبادل بالبلاد المغاربية خاصة في المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر؛ فذكرت أن مسألة الزواج كانت تتم بشكل عادي بين مغاربة وجزائريي الحدود، وأن التنقلات أو الهجرات الاختيارية كانت لأغراض متعددة.
وبينت حدوش أن إقامة الجزائريين بالمغرب وإقامة الجزائريين بالمغرب لم تكن تطرح أي إشكال؛ فامتلاك العقارات كان ممكنا والحصول على الجنسيتين كان سهلا والتنقل بين البلدين كان يسيرا وبدون جوازات.
وأضافت أن هجرة الجزائريين نحو المناطق الحدودية وخاصة مدينة وجدة كانت بسبب الحروب التي خاضتها فرنسا في الجزائر، والمضايقات التي كان يقوم بها المعمر الفرنسي من خلال سياساتها المتعلقة بالإدماج والتجنيس والتجنيد، وكانت أيضا هجرات من أجل تنظيم المقاومة وجيش التحرير.
من ناحية أخرى، ذكرت الباحثة أن المغرب، وخاصة المنطقة الشرقية، قد شكل قاعدة خلفية لثورة الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي منذ القرن التاسع عشر، مشيرة إلى أن المهاجرين الجزائريين بوجدة ساهموا في حرب التحرير ماليا، كما أن النساء قدمن الذهب، وتطوع الشباب الجزائري بجيش التحرير.
كما تناولت الباحثة في مداخلتها قضية الهجرات في فترة ما بعد استقلال الجزائر، وكذا المأساة المتعلقة بتهجير المغاربة من الجزائر سنتي 1963 و 1975.
أما الباحث التونسي حمدي يمن فتناول في مداخلته مسألة الهجرة والمهاجرين بين المغرب وتونس في الفترة التي سبقت الاستعمار، وذكر أن هجرة التونسيين إلى المغرب لم تكن كبيرة بسبب العامل الجغرافي، وكذا غياب ثقافة الهجرة لدى التونسيين عكس المغاربة، إضافة إلى التخوف الذي كان يسود التونسيين بخصوص الجهة الغربية التي جاء منها المستعمر الفرنسي.
وذكر الباحث حمدي يمن أن التونسيين كانوا يطلقون على المغرب اسم “المغرب الجواني” أي المغرب الغامض، وأنه بلد يتميز بكثرة الطرق الصوفية والصلحاء والشرفاء والمتصوفة، ولما استعمرت فرنسا تونس سنة 1881 هاجر التونسيون إلى المغرب، وشجعهم على ذلك الجانب الديني ممثلا في وجود حكم إسلامي في المغرب.
وأشار الباحث إلى أن موجة الهجرة التونسية إلى المغرب ستتصاعد سنة 1912 بسبب حاجة الاستعمار الفرنسي لمترجمين، وبداعي تجنيد فرنسا للتونسيين داخل الجيش الفرنسي لمجابهة مقاومة الريف؛ هذا التجنيد -يقول يمن- لم ينجح بسبب التقدير الذي كان يكنه التونسيون لعبد الكريم الخطابي، كما تحدث الباحث أيضا عن هجرة اليد العاملة التونسية لمناجم خريبكة بالمغرب.
هيأة التحرير